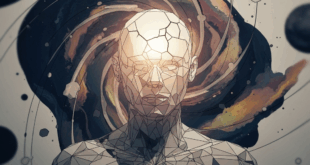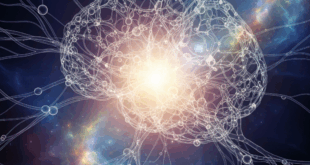المعراج الصوفي والتأويل الذوقي
عبد القادر فيدوح – جامعة قطر
التأويل والكشف الصوفي
أ ــ الكشف والمشاهدة
ينحو التأويل في هذا البحث منحى خاصا باعتماده المعرفة الذوقية سبيلا له. وسيكون حديثنا في هذا المجال عن المتصوفة، مركزين على الفيض الكشفي بما هو رؤية جمالية تنطلق من الفعل الاعتقادي، من منظور ان المتصوفة وظفوا أداة القلب في توصيل ممارستهم الكشفية وخطابهم المعرفي الذي يتعارض مع الخطاب العقلي والدليل البرهاني، وبذلك يكون الذوق هو مصدر طاقة المتصوف من حيث هو ذوق كشفي إلهامي جمالي، يأتيه عبر حالات ومقامات تمر بها النفس في وضع مخصوص، يستطيع الصعود به الى ذات الحق عبر وسيلة الاتصال بالالهام والأحوال، معتبرا ذلك موهبة الهية اختص الله بها صفوة المقربين الذين يتفانون في سبيل معرفة صفات التوحيد بقلوبهم بوصفها “معرفة مباشرة للذات الالهية، وما لها من صفات الوحدة، اذ هي لا تحصل عن طريق من طرق التعلم أو الاستدلال، وانما هي إلهام أو نفث في الروح لا يدانيه أي ضرب من ضروب المعرفة الأخرى، سواء في موضوعه أو منهجه[1]
إن مسعى التأويل عند المتصوف هو المعرفة، ويستمد رؤيته من الحضرة التي يدرك بها الأشياء ادراكا ذوقيا، ويتجسد موضوعها في الوصول الى الله، كما عير عن ذلك رويم(302 هـ) من أن المعرفة للعارف مرآة إذا نظرا فيها تجلى له مولاه[2] من خلال هذه الحضرة الربوبية على أساس من الذوق الروحي والكشف الالهي والحس الجمالي. أضف الى ذلك أن التأويل عندهم يتوزع بين إدراك العقل وإدراك القلب أو على نحو ما اصطلحوا عليه بالإدراك العلمي والإدراك المعرفي ” والفرق الجوهري بين المعرفة والعلم، أن المعرفة إدراك مباشر للشيء المعروف، والعلم إدراك حقيقة من الحقائق عن الموضوع المعلوم. والمعرفة حال من أحوال النفس تتحد فيها الذات المدركة، والموضوع المدرك والعلم حال من أحوال العقل، يدرك فيها العقل نسبة بين مدركين سلبا أو ايجابا، أو يدرك العقل مجموعة متصلة من هذه النسب “1“، وفي هذا النوع من الكشف الروحي تتسع رؤية الصوفي من خلال تأويله الشمولي للأشياء التي ترتفع في نظره من الاعتقاد الى التجربة الروحية بفنائه عن نفسه وعن الخلق، فيتحد بالمحبة الالهية، وكأن هذه المحبة هي خلاصه الوحيد وطريقه الأمثل للمعرفة اليقينية التي يستمدها الصوفي من تفسيراته وعباراته في التوحيد من خلال وحدة الشهود/ الوجود.
واذا كان التجلي الالهي هو هدف المتصوف لبلوغ المعرفة الحقة، فإن حرصه على مراعاة جانبي الظاهر والباطن في معرفة النص قائم على دعامة القلب لا العقل، مركزا على المسألة التي تعرضها الآية، ببيان أثرها في القلب بما يسمونه الاشارة، وقد أشار أبو العلا عفيفي الى أن ابن عربي ” يبني تأويله لآيات العبادات على أساس أنه لا تعارض بين معناها الظاهر ومعناها الباطن، وأن المؤول يرتفع بالمعنى الظاهر الى مستوى أعلى وأعمق روحانية، لأن ذلك أشد اتصالا بنفس الانسان وقلبه، والانسان مؤلف من نفس وبدن، وكلاهما في نظر ابن عربي مخاطب بالتكليف “2“، وهكذا تقوم المعرفة التأويلية، من هذا المنظور، على أساس من الذوق الروحي، والكشف الالهي.
ب ـ رحلة الكشف
إن المتتبع للتجربة الصوفية يدرك أن النفاذ إلى جوهر الكون مفاده البحث في مظاهر الجمال الإلهي المطلق التي تعكسها صورة الجمال الحسي المخلوق في ظواهرها المتعددة، وهي إحدى السمات التي من شأنها أن تحدد العلاقة الانطولوجية بين الذات الإلهية وصفات العالم، لذلك نجد البحث الجمالي لدى المتصوفة ينتقل من النظر العقلي إلى المشاعر القبلية، أو من تجاوز العالم المدرك اليقيني إلى احتضان عالم الحقيقة، إلى التسامي عن هذا الدرأ لما يشوبه من شوائب شائنة، وهذا يجعلنا ـ ونحن نقارب التفكير الصوفي ـ ننتقل من عقلانية التصور والمعرفة البرهانية إلى يقينية الإحساس بالمشاهدة، أو ننتقل من الطريق النظري التجريدي إلى النظر القلبي.
وإذا كانت فلسفة الجمال تعنى بالأشياء في ذاتها، ومن حيث النظر إليها وفق منظور العلاقة الشكلية الناتجة عن الشعور بالانسجام فإن الفكر الجمالي لدى المتصوفة يعنى بالنظر المطلق المرتبط بفكرتي الفناء ووحدة الوجود، فالرؤية الصوفية تنظر إلى الأشياء بإطلاق، متجاوزة بذلك فكرة التجريد.
هكذا ـ إذن ـ يبدو الجمال في نظرهم متجاوزا مظاهره الحسية مقابل النظر في الوجود على المستوى الانطولوجي الذي من شانه أن يعكس القيمة الجوهرية لتحقيق الجمالية، وما تعكسه هذه الصورة من تطابق لآثار جمالها في الوجود.
وعلى الرغم من تعدد مظاهر الجمال الكوني إلا أن هذه المظاهر في تعدد رموزها وكثرة موجوداتها تبدو موحدة من منظور وحدة: الوجود / الشهود، وهذه رؤية تتأسس على إثبات قيمة ارتباط الصوفي بحبه المتفاني وعشقه لذات: الخلق / الحق. ومن ثمة كان اكتشافهم العشق الإلهي طريقا إلى معرفة الأسرار.
لقد كانت الرؤية الصوفية نزوعا نحو معرفة إرادة الحق عبر رموز الموجودات، ومالها من التجلي والقدرة الإبداعية من ذات الحق، وهو ما برهن عليه المتصوفة من خلال تعلقهم بالباري جل اسمه، وحبهم له حبا فاق النظر العقلي إلى الارتباط بالمشاهدة والفناء في ذاته، وهذا ما تعبر عنه فكرة الحلول[3] سواء بحلول ذات الحق في الوجود أم بحلول ذات الخلق بكليته في محبوبه، وأن الخلق متحد بعين الحق صفة وليس حقيقة بحسب ما ورد في الحديث القدسي: ” من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبسط بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته، وذلك لمن يكره الموت وأنا أكره مساءته “[4].
الحب غاية الغايات: انطلاقا من تجاوز ميدان العقل الذي تظهر فيه الأمور بالقوة، إلى ميدان الوجدان المليء بالغرائز والشهوات حيث تظهر نزوع الذات الإنسانية إلى لذاتها ومشتهياتها، وبينما يهيم الإنسان العادي في هذه الملذات الاستهلاكية البهيمية ليصل إلى نشوة الحياة والتمتع بها، يتجاوز الصوفي ذلك بعد أن يتمكن من نور اليقين، ويسمو باللذة من معناها “الترابي” إلى معناها ” السماوي ” إذ ليس فضل الإنسان بالاستمتاع بملاذ الحياة ولكن بأعلى قيم الوجدان في الحياة الروحية الخصبة.
ومن ثمة فإن الحب المتبادل بين الإنسان والله هو في أساسـه حـب روحي كما ورد في الآية الكريمة: ” فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّةٍ على المؤمنين أعزّةٍ على الكافرين ” (المائدة54).
إن الحب صفة مائزة في كل المخلوقات، وتجربة وجدانية معاشة يدفع إليها تحصيل الرغبة في إشباع الجسد، نشوة اللذة، وهو ما تظهره الغريزة الحيوية في المخلوقات، والجبلة الطبيعية للإنسان، على حد ما أظهرته الفلسفات منذ أفلاطون الذي أثبت طبيعة هذا الحب على أنها قائمة على الرغبة EROS بوصفها ” أعظم قوى ” بغرض تخليد الإنسان نوعه، وتحقيق توحده في من يحب حتى يصل إلى أسمى فضائل الكون، وهي الخبرة. لذلك ينبغي الابتعاد عن جمال الدنيا المشوب بالدرأ، وهو ما تعرضت له الفلسفات القديمة، متصورة الحب غريزة يصل بها المحب إلى الخير في حال التمسك بالنزعة الخلقية لهذه الفضيلة، فضيلة الخير، في حين يضل الصواب إن هو أهملها، وذلك ما أورده أفلوطين حين قال: بعض الناس يؤثرون الجمال في هذه الدنيا ويقفون في حد التأمل فيه، أما هؤلاء الذين يتذكرون الجمال الأول دون أن يحقروا الجمال في الدنيا، فهم يعجبون بما يرون من جمال في هذه الحياة، ولكنهم لا ينظرون إليه إلا على أنه صادر عن الجمال الخالد وأثر من أثاره، وهؤلاء يحق لهم أن يحبوا الجمال دون أن يعتريهم قط خجل في حبهم. أما الأولون فقد يقعون أحيانا في الشر وهم المنشدون الخير. في الحق كثيرا ما تقود الرغبة في الخير إلى الوقوع في الشر[5].
وإذا كان الأمر كذلك في نظر فلاسفة الإسكندرية الذين ولعوا بتمجيد هذا النوع من الحب الإلهي وبالدعوة إلى اتخاذه طريقا إلى الله في الحياة، فإن المتصوفة يتميزون عن باقي المخلوقات، هائمين بودهم الخالص، وحرقة وجدهم في ذات الخالق، فكأن الحب عندهم يسري ـ كما وصفه ابن عربي ـ سريان ” اللون في المتلون”[6].فهم يتميزون باتخاذهم المشاعر العاطفية ـ في صفائها ـ طريقا إلى المشاعر الروحية، وما يتخذه عامة الناس من تغليب النسبي المطلق، والآني على الدائم الثابت، لإشباع الذات التذاذها العاطفي المؤقت. فإن المتصوف الذي يتخذ المطلق مبدأه ومنتهاه يهمه الإشباع الروحي الدائم الذي هو خاصية من خصائص أهل التوحيد، وفي هذا إضافة معنى جديد إلى معنى الحب بالمنظور التأويلي ” وكان لذلك أثر كبير في الأدب عند شعرائهم الذين عبروا عن عواطفهم وأفكارهم فأضفوا على الجمال معنى جديدا، وخلقوا بذلك في الأدب وسائل للتعبير عن المعاني الروحية وجمالها، فكان للمعاني الغزلية في شعرهم روعة وجدة لم يكن إليها سبيل إلا بتجاوز حدود المادة في النظر إلى الجمال الحسي[7]
ذلك ما خص به المتصوف، وبه وصف في تعلقه بحبه إلى ربه، فكان الحب متبادلا بين الله والإنسان[8] وبالحب يعتلي صهوة الرحلة، الرحلة إلى الله، بغرض الاتصال بالحقيقة، حيث السفر إلى إرادة الحق والهيام به اشتياقا حتى تصير الخلة بينه وبين محبوبه، وهذا ما تطرحه فكرة الاتحاد[9] بحسب مقولة البسطامي: ولقد نظرت إلى ربي بعين اليقين بعد أن صرفني عن غيره، وأضاء في بنوره فأراني من عجائب سره، وأراني هويته، فنظرت بهويته إلى إنائيتي فزالت: نوري بنوره وعزتي بعزته، وقدرتي بقدرته، ورأيت إنائيتي بهويته، وأعظامي بعظمته، ورفعتي برفعته، فنظرت إليه بعين الحق، فقلت له، من هذا ؟ فقال: هذا لا أنا ولا غيري.. فلما نظرت إلى الحق بالحق، رأيت الحق بالحق، فبقيت في الحق بالحق زمانا لا نفس لي، ولا لسان ولا أذن لي، ولا علم، حتى أن الله أنشأ لي علما من علمه ولسانا من لطفه وعينا من نوره[10]. كما عبر البسطامي بقوله أيضا: ” إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني “. وقد روي عن ابن سبعين انتحاره لهذا الغرض، ذلك لأن الموت في نظر الصوفي على وجه العموم فعل يجسد حقيقة الاتحاد المطلق بين ذات الحق وذات الخلق، وبه تمحى الوصلة الفاصلة بين الحب والمحبوب.وقد لا نستغرب إذا سمعنا ذلك عند ابن سبعين الذي عجل بموته تقربا من الله واشتياقا إلى لقاء محبوبه والاتحاد به.
وفي هذا إشارة إلى حقيقة الفناء لدى الصوفي وغيبته بمحبوبه عن حبه حتى يظن أنه أتحد وامتزج فيه أو ” هو نفسه “. وللحلاج وقفة متأنية في العلاقة المتبادلة بين الله والإنسان وهو ما أطلقت عليه الدراسات الحديثة نظرية الحلاج في الـ” هو هو ” استنادا إلى إحدى مناجاته: ” يا من هو أنا وأنا هو “، أو كما روي عن السقطي قوله: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر يا أنا[11] . فالتوحيد عند المتصوفة ـ في غالب الأحوال ـ هو امتزاج الروح والوعي بالجوهر المطلق، حيث الحق، وذلك بعد إسقاط العنصر الناسوتي في وجود العالم الصغير، لينصهر في صفات الألوهية. وقد رأت بعض الدراسات[12] . أن المقصود هنا ليس تماهيا من خلال توحد في الجوهر، بل تصعيد وفناء البشري بالرجوع إلى منبعه أو مصدره، وربما كان هذا هو التصور المفهومي الذي يمكن للذات أن تمارسه في مناخ توحيدي خالص.
إن تعلق المتصوف وشغفه بربه، ومحو ذاته من أجل إثبات ذات محبوبه، يعد صفة مائزة وخاصية من خاصيات الإيمان والتدليه في المحبة الخالصة، وهذا ما أشار إليه المتصوفة الأوائل في أثناء ذكرهم صفات المحبة، وهو ما أورده القشيري عنهم من أن المحبة هي: ” محو المحب بصفاته وإثبات المحبوب بذاته “[13] . فالمكاشفة بمحبة الحق تعالى هي ذوبان الذات الناطقة ـ معنويا ـ في ذات الله، عندئذ ترتفع مقامات المتصوفة إلى المقامات العلية انطلاقا من فنائهم في حبهم، وهو ما علق عليه الهجويري بقوله[14]: إنه عندما يبقى المحبوب ينبغي أن يفنى المحب، لأن غيرة المحبة يفني بقاء المحب لتصير لها الولاية المطلقة، ولا يكون فناء صفة المحب إلا بإثبات ذات المحبوب، ولا يجوز أن يكون المحبوب قائما بصفته لأنه لو كان قائما بصفته لكان غير محتاج إلى جمال المحبوب، فعندما يعرف أن حياته لا تكتمل إلا بالمحبوب، فإنه بالضرورة يطلب نفي أوصافه، لأنه يعلم أنه مع بقاء صفته يكون محبوبا عند المحبوب فصار بمحبته للحبيب نفيا لنفسه.
هذا هو وضع الصوفي الفاني في طلبه الخلق الباقي بالحق، ومن ذلك كانت صلته بمولاه أسمى من أية صلة حتى من صلته بنفسه، كما عبر عن ذلك أحدهم[15]:
سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم أدنى إلى النفس من وهمي ومن نفسي
مازلت مذ سكنوا قلبي أصون لهم لحظي وسمعي ونطقي إذ هم أنسـى
فمن رسولي إلى قلبي ليسألهم عن مشكل من سؤال الصب ملتمـس
حلوا الفؤاد فما أندى ولو وطئوا صخرا لجاد بماء منه منبجــــس
وفي الحشا نزلوا والوهم يجرحهم فكيف قروا على أذكى من القبــس
لأنهضن إلى حشري بحبهم لأ بارك الله فيمن خانهم فنســـى
والصوفي في هذه الحال فان بكليته في ذات الحق، باق في صفات الذات العلية، بغرض الوصول إلى كينونة ثالثة، وذلك عبر مقولة الحب الخالد بين المحب الذاكر والمحبوب المذكور من غير فلاح ولا كسب.
وإذا كانت المعرفة اليقينية مرتكزة على مقومات البرهان بوصفه خاصية في المذهب العقلي، إذا كان الأمركذلك بحسب لسان الحال، فإن المذهب الصوفي معني بمعرفة الحقيقة عن طريق الوجدان، على اعتبار اليقين،هنا، هو عين القلب، وفي ذلك سـرّ المحبة المتشوقة، وهو ما أورده ـ على حد قول الغزالي ـ أرباب الأحوال، في جميع مواقفهم، من أن المحبة هي أن تمنح كلك لمن أحببت حتى لا يبقى لك منك شيء. وهو ما ذكره القشيري في أثناء حديثه عن المحبة بوصفها محو المحب بصفاته، وإثبات المحبوب في ذاته. أو ما عبر عنه البسطامي بقوله: خرجت من الحق إلى الحق حتى صاح مني في: يا مـن أنت أنا، فقد تحققت بمقام الفناء في الله[16] .
إن الحب الحقيقي عند المتصوفة هو الفناء في ذات الحق، والاتحاد به، وهو ما تزخر به مشاعر الصوفية التي تجعل الحب بمثابة سر الوجود وعلته الأولى. قيم الحب والخير والجمال في العالم المرئي إنما هي فيض من الجمال الأزلي المطلق، وفي ذلك يقول عبد الرحمن جامي: في الوحدة حيث الوجود الموحش، وحيث العالم سر في باطن الحق محتجب بأستار العدم كان ” الوجود المطلق ” المنزه عن ” أنا” و ” أنت ” وعن كل أثنينية، لم يكن ذلك الجمال معروفا إلا لذاته، متجليا إلا لنفسه في نفسه بنوره الأزلي، وفيه من القوى ما يبهر العقول جميعا.
ولكن الجمال يأبى البقاء محتجبا مختفيا، لا تراه عين، ولا يسعد به قلب، لذلك فك عقاله. وحطم أغلاله، وتجلى في الكون بصورة كل جميل.
تلك طبيعة الجمال، وذلك أصله الذي فاض على الوجود من عالم الطهر والصفاء، فسطعت شمسه على الأكوان وملأت ما فيها من النفوس فكل ذرة في الوجود مرآة تعكس صورته: تتفتح عنه الأزهار وتشدو به الأطيار، ويستمد النور من ناره الضوء الذي يخدع به الفراش فيجره إلى حتفه. حذار أن تقول ” هو الجميل ونحن عشاقه ” فلست إلا المرآة التي تنعكس عليها صورته ويرى فيها وجهه، هو وحده الباطن وأنت الظاهر والحب المحض ـ كالجمال المحض ـ ليس إلا منه يتجلى لك منك فيك، فإذا لم تستطع أن تنظر إلى المرآة فاعلم أنه هو المرآة أيضا، هو الكنز وهو الخزانة أما “أنا” و ” أنت ” فلا محل لها هنالك، تلك أوهام خادعة لا حظ لها من الوجود[17] فما كان من هذا الجمال المطلق إلا أن تجلى في جميع صور الجمال لكي يعشق، لأن طبيعته الأزلية قد اقتضت ذلك، بل إن ما سمي بالحب الإنساني ليس على الحقيقة إلا حبا إلهيا، وبرزخا موصلا إليه، لذلك كانوا يرون في جمال العالم الكبير جمال الإله، وفي الخير الذي يفيض به، الخير الرباني، لذلك كان الدافع البشري هـو ” حب الاتصال بالمحبـوب ” ـ على رأي ابن عربي ـ بعد أن اشتاقت إلى الاتصال به والحنين إلى الرجوع إليه لأنها مجلى من مجاليه، وهذا الشوق الذي يدفعها إلى الفناء عن ذاتها ويرمي بها في أحوال الجذب والوجد، هو وحده السبيل إلى عودتها إلى وطنها القديم[18].
إن تحقيق هذا المقام في نظر المتصوفة وهو المعبر عنه: بالحب لا يمكن أن يحل في وجدان كل مريد إلا إذا صفت نفسه من كل منقصة ومن كل شائبة، لأن عناصر العالم الصغير مستمدة من الوجود المطلق المنبثق عن ذات الحق، ولتأكيد اتحاد حقيقة الوجود أظهر الحق صفاته في سر الخلافة التي خص بها الإنسان: ” إني جاعل في الأرض خليفة “(البقرة30)، لأنه إحدى آياته الدالة علة وحدانيته ومحبته، لذلك حق للإنسان السعي وراء تحقيق غاية الاتحاد، فكان من شأن ذلك أن كانت صفات الله الكمالية تظهر على سائر المخلوقات الدالة على ذاته، فكان الحب، وكان الاتحاد، وهو ما عبر عنه جلال الدين الرومي: ” ها هو ذا قد طلع، لم تر السماء له نظيرا في يقظة أو حلم، وحوله من النار الأبدية لا يقوى الطوفان على إخمادها. يارب لقد أسكرتني خمر حبك، وتهدم كل شيء في بيت جسمي الطيني لما آنس صاحب الكرم قلبي الموحش، أشعلت الخمر صدري وامتلأت بها عروقي. فلما شاهدته العين، سمعت هاتفا يقول: أحسنت يا خمر الملوك يا كأسا عديمة المثال ! عمل الحب بيده القوية في هدم بيوت الظلام، من سقفها إلى أرضها، فلا يتسرب إليها إلا بصيص من الأشعة الذهبية خلال شقوقها، ولما لاحت لقلبي لجة الحب فجأة ألقى فيها بنفسه وقال ” لن تراني ” [19] !..
والنص فيما يشير إليه، أو ما يفهم من دلالته دعوة إلى الارتباط بالمحبة الإلهية من خلال الصفات التي هي بمنزلة أشعة نور الحق وكمالاته التي انعكست على الموجودات. ومن هنا، ارتبط حب الإنسانية بمحبة الألوهية. وبهذا المعنى ستصبح الأشياء في موجوداتها جزءا من الحب الإلهي. ومن هنا أيضا، فسر ابن عربي طريقة الحب الصوفي بنظرته الشمولية،من أنه كل الوجود وكله الوجود، وهي نظرة كونية يسعى بها المتصوف إلى الارتقاء نحو الكونية الخاصة بالجمال الإلهي “.. وكذلك الحب ما أحب أحد غير خالقه، ولكن احتجب عنه تعالى بحب زينب، وسعاد، وهند، وليلى، والدنيا، والدرهم، والحياة، وكل محبوب في العالم، فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون، والعارفون لم يسمعوا شعرا، ولا لغزا، ولا مديحا، ولا تغزلا إلا فيه من خلف حجاب الصور، وسبب ذلك الغيرة الإلهية أن يحب سواه، فإن الحب سبيله الجمال، وهو له، لأن الجمال محبوب لذاته، والله جميل يحب الجمال فيحب نفسه (..) فعلى كل وجه ما متعلق المحبة إلا الله[20] .
ولعل ما يلاحظ هنا هو أن ابن عربي بتعرضه إلى المحبة في نظرتها الشمولية، إنما يريد بذلك إظهار حقيقة الإنسان الكامل عن ” طريق محو المحب بصفاته، وإثبات المحبوب بذاته ” وفي الإنسان تتجلى جميع الصفات، وبهذا تصبح الوظيفة الدينية للإنسان الكامل من حيث هو واسطة بين الحق والخلق في مقابل وظيفته الميتافيزيقية، من حيث هو مبدأ يجمع بين طرفي الحقيقة: الحق والخلق. فالحركة الصعودية للحق من عالم الظاهر إلى عالم الذات تتم في حالة الشعور بالاتحاد الذي يشعر به الصوفي، وهذا إحلال للتصوف محل الميتافيزيقيا. ويذكر الجيلي في موازاة المراحل، مرحلة الوحدة، ومرحلة الهوية، ومرحلة الانية، ثلاث أحوال يشعر بها الصوفي: وهي إشراق الأسماء الإلهية، وإشراق الصفات، ثم إشراق الـذات[21] .
حقيقة الجمال ووحدة الوجود
أ ــ الجمال جوهر الألوهية
لقد تميزت حقيقة الخلق من إرادة الحق، وظهرت صفات الله في صفات الوجود بالحب حيثما تجلى لنفسه في نفسه، من منظور أن ذات الحق تجلت في ذات الخلق، ولما علم الحق نفسه فعلم العالم من نفسه فأخرجه على صورته فكان له مرآة يرى صورته فيه، فما أحب سوى نفسه.. لأنه لا يرى سوى نفسه[22]. فالذات الإلهية بهذا المنظور تعرض صفاتها في ذوات مدركة، تشكل مراتب الوجود متجليا في جميع أنواع المخلوقات، أشرفها صفات الإنسان بوصفه مخلوقا أسمى يمثل العالم الأصغر، ويحتوي على صورة المحاكاة، ويكون بمقدور هذا الإنسان التمكن من تأكيد صفات الله بدءا من ذاته، امتثالا لما قاله الرسول (ص): ” من عرف نفسه عرف ربه ” وهي الصورة الأولى التي يقبض عليها الإنسان لمعرفة ذات الجلال في ذاته، صورة يمكن اعتبارها متراوحة بين التنزيه والتشبيه.
إن النفس الإنسانية في نظر المتصوفة جوهر روحاني، مستمدة من نور واجب الوجود، وهي سر حركة البدن في ظاهرها وباطنها، لذلك كانت وظيفتها معرفية، على ما جاء به الغزالي من أن: ” الحقيقة فقه السنة ” لما تقوم به ( النفس ) من دور في سبيل الوصول إلى المعرفة الكاملة والتي تليق بالإنسان بحكم خلقه على الصورة الإلهية، وليس هذا فحسب، وإنما الكمال الحقيقي في حصول المعرفة بحسب رأي الأمير عبد القادر الجزائري ( أحد المتصوفة المتأخرين )، هو الذي يتحقق باجتماع العقل والروح معا، لأن العقل على ما يقول إذا امتزج بالروح امتزاجا معنويا ظهرت العلوم حينئذ في النفس[23] .
لقد أقر المتصوفة الجمال في ذواتهم التي تمثل أسمـى المخلوقـات، ـ وتنعكس عليها صفات الحق ـ معنى ذلك أن ما ينعكس عليه الجمال يتحول إلى جميل، ففي نظرهم، أن وجود معاني ” الخلق في صفاته ” تعكس صفات ” ذات الحق ” وبيان ذلك أن الوجود بعينه يعني وجود معاني الخلق في صفاته التي تعكس صفات ذات الحق والاتحاد، على اعتبار أن الإنسان أسمى الخلق، وأنه خليفة الله في الأرض، ومن ثمة يكون كمال التوحد والاتحاد عبر الجهاد الروحي نفيا للصفات الناسوتية، وتحقيقا للصفات الإلهية، وهو ما عبر عنه الحلاج الذي تبيّن له أن كمال التوحد نابع من إثبات الصفات في ذات الحق بقوله:
أدنيتني منك حتــــى ظننت أنك أنـــــى
رغبت في الوجد حتــى أفنيتني بك عنــــي
مازجت روحك روحــي في دنوي وبعـــادي
فأنا أنت كما أنـــــــــــك أنى ومــــرادي
* روحه روحي وروحي روحه أن يشأ شئت وأن شئت يشأ
* فإذا أبصرتني أبصرتـــه وإذا أبصرته أبصرتنــي
وفي هذا فعل الوجود الذي يعكس صورة الاتحاد والتمام والكمال بعيدا عن كل تجسيم وتحديد لصفات الحق، وعلى الرغم من ذلك فإن مذهب الحلاج ـ ومن حذا حذوه، بتناقضه الظاهري ـ في العلاقة المتبادلة بين الله والإنسان والعـالم، متسق في أعماقه. فالله هو الحقيقة المطلقة التي لا توصف ولا تحد، ولا بداية أو نهاية لها، والعالم بمظاهره المختلفة المتنوعة ليس إلا تجليات لهذه القوة.. ( ومن ثمة ) فإن منطق العلاقة بين الله والإنسان في الصوفية لا ينتهي بالضرورة إما إلى ” إنسانية ” الله أو ” ألوهية ” الإنسان، وكلا الأمرين مناقض لمفهوم التنزيه العام الذي تنص عليه الشريعة التي ترفض أية علاقة بين الله والبشر إلا عن طريق وحي الأنبياء[24]، أو أيّ تشبيه أو تحيّز أو تعدد للذات المقدسة. ومن ثمة فإن هناك علاقة مباشرة بين الله وعباده جميعا، علوية وسفلية ” وما كان لبشر أن يكلمه الاّ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ” (الشورى51)، ” ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ” (ق16)، ” وإذا سألك عبـادي عني فإني قريـب ” ( البقرة186) .
إن للجمال في تأويل المتصوفة غاية أسمى، وذلك بعد انتقالهم من تفانيهم في الهيام بحسن الخلق الذي يشكل المادة الحقيقية للوجود إلى عالم الأظلة، حيث الحنين إلى الأصل، وهذا ما يعكس انتقال حركة الكائن في الوجود إلى المكانة الأسمى باشتياق النفس إلى الفضائل في صفات الحب الإلهي، ومن ثمة كانت الصفات الجمالية بمثابة وسيلة للتقرب بها الىحـب
الله لأنه أهل لأن يحب، أولا لأنه مصدر النعم التي لاتنقطع، فلاسبيل لأن ينقص حب المنعم بها، وثانيا: لأن الله أهل لأن يحب ” لما هو أهل له من الحب لجماله وجلاله[25].
ولعل في هذا النزوع الجمالي مايمكن الفرد ـ في تأويلاتهم ـ من معرفة الجمال الالهي عبر التجليات المتعاقبة للعيان، كما ورد ذلك عند ابن عربي في كتاب ” التجليات ” في اثناء تنوع الكشف بغية إمكان معرفة النفس، منطلقا من إثبات تجليات الكمال في صفات الله، وبيان ذلك أن ليس لأي معرفة أن تدرك الصواب بغير معرفة الحق عبر التجليات الجمالية للذات الالهية، وهو مالايمكن ان يكون في مقدور الانسان، مؤكدا أن المعرفة الحقة ثابتة في صفات الحق، وذلك بقوله: ” أنا ألذ لك من كل ملـذوذ، أنا أشهى لك من كل مشتهى، أنا أحسن لك من كل حسن، أنا الجميل، أنا المليح “[26]. ولعل مرتبة الحب هنا أسمى من أي مرتبة أخرى، بمعنى أنه عندما يتجلى المحبوب ينبغي أن يفنى المحب، على غير عادة الحب الطبيعي، والإنسان الصوفي لابد له من أوليات في الحب الطبيعي، ثم يتدرج إلى المحبة التي تفنى في ذات الحق
إن الحب الإلهي المبين في هذه الرسمة هو تجاوز للحب الطبيعي والروحاني، وفي هذا يقول أبو الحسن الديلمي (ت 371هـ) في أثناء حديثة عن رتب الحب: ” واعلم أنا إنما بدأنا بذكر المحبة الطبيعية لأنه منها يرتقي أهل المقامات إلى ماهي أعلى منها حتى ينتهي إلى المحبة الإلهية. وقد وجدنا النفوس الحاملة لها إذا لم تتهيّأ لقبول المحبة الطبيعية لا تحمل المحبة الإلهية، فإذا هيئت بلطف التركيب وصفاء الجوهر ورقة الطبيعة وأريحية النفس ونورانية الروح، قبلت المحبة الطبيعية، ثم ارتقت وطلبت كمالها والوصول إلى غايتها والارتقاء إلى معدنها، فنازعت أصحابها وهم المحبون. فأزعجتهم حتى ترتقي بهم إلى الإلهية درجة درجة، كلما قربت درجة ازدادت شوقا إلى مافوقها حتى تصل بالغاية القصوى “[27]
إن المتصوفة في هذه الحال يدركون أن التأمل في ذات الجلال يمنحنا القدرة على حب الجمال في كنفه، على خلاف مايرتبط الجمال المادي بعامة القوم حينما يتعلقون بالجمال الدنيوي، في حين يهيم الصوفي في حبه المتفاني للجمال الخالد المتعلق بجمال الروح، المتوصل اليه بالكشف الباطني، وليس عن طريق المعرفة الحسية التي تدعو اليها النظرية المادية، ذلك أن السبل الصوفية تهتم بكشف الذات الإلهية في النفس من منظور النزوع والاشتياق، وفي هذا الشأن يرى ابن عربي بأن الله أوجد العالم في غاية الجمال والكمال خلقا وإبداعا، فإنه تعالى يحب الجمال، وما ثم لاجميل إلا هو فأحب نفسه، ثم أحب أن يرى نفسه في غيره، فخلق العالم في صورة جماله، ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر، ثم جعل عز وجل في الجمال المطلق الساري في العالم جمالا عرضيا، مقيدا يفضل آحاد العالم فيه بعضه على بعض بــين جميل وأجمل.[28]
إن صورة الموجودات في نظر وحدة الوجود عند ابن عربي هي عين الحقيقة الواحدة، ومن ثمة فإن ما يبدو لحواسنا لايعدو كونه تجليات لصورة الحق ذي الجلال، على اعتبار أن ما تستنتجه عقولنا من وجود خارجي لايمثل إلا صورة وجود الاتحاد بكشف أسرار الوجود، وقد ميز الحق تجليه في صورة الخلق، وأثبت ذاته في صفاته العيانية الماثلة في هيئة الإنسان بأسمى معاني الكمالات النفسية والخلقية، ولأنه يتميز بخاصية العقل والقلب، لذلك نجد ابن عربي يركز على حقيقة وجود الإنسان بوصفه يجسد مكانة الكمال في الوجود المحدود بحقيقته الذاتية التي وصفها بوجود الإنسان الأصغر الذي يعكس صورة الإنسان الأكبر والذي يمثل خليفة الله في الكون بما له من أفضلية على سائر الموجودات بدءا بالملائكة، وهو ما أشار إليه ابن عربي في أثناء حديثه عن إثبات عينه في إثبات الكون: ” فاقتضي الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عين جلاء تلك المرآة، وروح تلك الصورة …” وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبر عنه في إصطلاح القوم بالإنسان الأكبر[29] بوصفه المرآة الصافية التي تعكس نتاج الشعور بالانسجام.
ومن هنا يمكن أن نعتبر مواقف ابن عربي في تأكيده لوحدة الوجود، مواقف نابعة من القيمة الجمالية فيه ( أي في الوجود ) من حيث وحدة العلاقات بين الاشياء المتفاوتة في مراتب الكمال، المرتبطة بإثبات مصدر الوجود كله في حقيقة الذات الإلهية، وعلى هذا يمكن أن تتحقق الصورة الجمالية في حقيقة الوجود الإنساني، من العالم الأصغر الذى هو الإنسان إلى العالم الأكبر الذي هو الوجود كله، أو ما وصفته الدراسات الصوفية من أن الإنسان هو الذي اختزن فيه الحق كامن أسراره.
لذلك نجد تعدد صفات الإنسان في الفهم الصوفي متجاوزة حدود الفهم العادي من حيث كونه يجتمع بين صفتي: “إنسانية(الله)“أو”ألوهية (الانسان) ” لما في هذه الألوهية من أسماء عبر تفاوت في النوع الإنساني ضد مراتب الكمال، فإن رتب هذا التفاوت ترقى حتى بلغ منزلة قريبة من منزلة الألوهية عند أصحاب الحلول والإنسان الكامل هو من يصل إلى هذه المنزلة، وفي هذه الحال يتوقف الأمر على الجهة التي ينظر منها إلى الإنسان الكامل، فهناك جهات ثلاث: الأولى النظر إلى الإنسان من جهة الكيان الوجودي بوصفه ” الكلمة الفاصلة الجامعة ” التي تجمع في ” نشأته الانسانية ” جميع ما في الصور الإلهية من الأسماء، بهذا الاعتبار يكون الإنسان الكامل هو الجانب الإلهي الصرف من الإنسان، أو هو الجانب ” الانساني” الوجودي من الله، والجهة الثانية النظر إلى الإنسان من حهة كونه الصلة بين الله والعالم، وهنا الانسان الكامل يعني الأنبياء … والجهة الثالثة النظر إلى الإنسان على اساس المعرفة، وهنا يكون ” الإنسان الكامل” هو المتمكن من إدراك إنسانيته الباطنة، أي من حيث هي المظهر الوجودي لله[30] .
ب ــ الجمال والتجلي الإلهي
لقد اهتم المتصوفة بالجمال بوصفه وسيلة لإبراز الحقيقة الوجودية معتمدين في ذلك على ذائقتهم التأويلية التي تلغي التعامل مع الحقيقة، وتميل إلى التجاوب مع الإشارة أو ما أسموه بالتخريـج[31]، وليس التأويل الذوقي هنا كما تطرحه مدارك الحواس، وإنما بما يشكله التصورمن بعد روحي استبطاني يقوم بترويض النفس ومجاهدتها، وتمكنها من الارتفاع من العالم المجرد إلى مرآة النور المطلق في صفات الحق ذي الجلال.
ومن ثمة، فإن النهج ـ التأويلي ـ الصوفي يسعى في اجتهاده الى أن يكون شاملا وجذريا، وإذا يتجاوز الحدود المرسومة من قلب المذهب السني السائد فإنه لايدخل فـي حـيز” حقيقة” العصر حتى وإن كان يقول الحق[32]، والمتصوفة في هذا إنما يعتمدون على رؤية الجمال بعين اليقين، متخذين من المظاهر الجمالية في الكون طريقا الى حق اليقين بموجب التفاني في معرفة الله عن طريق الكشف، ومعنى ذلك أن الصفات الظاهرة للعين هي وسيلة يتقرب بها المتصوفة إلى جمال الحق، وفي هذا ماينم على تأثر الصوفية بالفلسفة الأفلاطونية التي اتخذت من الحب الجسدي طريقا إلى الحب الإلهي، إذ الجمال في الخلقية مرآة جمال الله، وهؤلاء يذهبون في شرحهم لخلق الكون إلى أن الأصل فيه الجمال الإلهي، وذلك أن الصفة الجوهرية في الجمال أنه بطبعه ميال إلى الظهور والإيحاء بنفسه، وهذا هو الباعث لدى الجمال الأقدس أن يخلق ليعرف بهم[33] وعلى اعتبار أن الله هو الوجود الحق وأصل كل الموجودات، أما الموجودات الظاهرية فهي واسطة لمعرفة جملة صفات الحق التي برزت في صفات الخلق.
من أجل ذلك تفاني المتصوفة في البحث عن سر الخليقة باعتمادهم هذا الحديث القدسي سندا لهم: ” كنت كنزا مخفيا فأحببت ان اعرف فخلفت الخلق لكي اعرف “.[34]
والحب في المعرفة ـ التأويلية الصوفية ـ مبني من وجهة أن الحق أحب أن يعرف على الصفات الكمالية، فظهر أو تجلى من كونه في صورة جمال الخلق، وإذا اتحد الخلق بالحق بلغ مقام التوحيد بمعرفة الصفات الوحدانية، وذلك بعد مشاهدتهم صورا بعلم اليقين، فأرادوا أن يعودوا إلى أصلهم بعد أن تبين لهم بالبرهان أن العالم السفلى ” الحادث الزماني ” واقع تحت الفساد مما يصعب ازالة شروره، لذلك فضلوا العودة إلى الباري جل اسمه، حيث المعرفة الحقة والوجود المطلق، والخير الأعلى، والنور الأتم. وهكذا، نرى التحويل الذي سيمارسه الصوفية على مفهوم الألوهية، فهي ليست مبدأ خلق وإيجاد، بل مبدأ حب، وما الخلق والإيجاد إلا مظهران من مظاهر الحب. ومن ثمة فإن جوهر الألوهية هو الحب، من هنا ـ مثلا ـ نرى الجيلي يبحث عن كل المبررات لإثبات ذلك بحثا في اشتقاق ذكـر اسم ” الله ” الذي أرجعه إلى أصل الفعل ” أله ” ” يأله ” بمعنى عشق، يعشق،ولذلك كان حنين الصوفي للعودة إلى أصله الإلهي ميلا إلى الذوبان في” الحب” كحقيقة، أو مبدأ كوني. إن حب الألوهية يخفي في ذاته حبا للحب مادام العمق الاصلي للألوهية هو الحب يقول ابن عربي:
ولما رأينا الحب يعظم قـــدره ومالي به حتى الممات يـدان
تعشقت حب الحب دهري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفاني
فأبدى لي المحبوب شمس اتصاله أضاء بها كوني وعين جناني
ويضيف:
وعن الحب صدرنـا وعلى الحب جبلنا
فلذا جئناه قصــدا ولهذا قد قبلنــا[35]
يقول تعالى: ” وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ” (الأنعام/59). ويقول جمال الدين الرومي: – مكاني في اللا مكان – أنا من أهوى ومن أهوى أنا.
يقول تعالى: ” الله خالق كل شيء ” (الزمر/62). ” ألا له الخلق والأمر ” (الأعراف/54). ” والله على كلّ شيء قدير ” (آل عمران/89). ” سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ” (فصلت/53). ” أو لم يكف بربك أنه على كلّ شيء شهيد ” (فصلت/53) ـ وقس على ذلك آيات أخرى تثبت صفاته الكمالية ـ.
يقول تعالى: ” ما خلق الله من شيء ” (النحل/48). ” إني جاعل في الأرض خليفة ” (البقرة/30).
– ” وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يُعيده ” (الروم/27).
السر المطلق للجمال يكمن عند المتصوفة في اشتياقهم العودة إلى صورة الحق، إلى حيث ماكانوا عليه في عالم الاظلة، حيث شعر الإنسان بغربته وانفصامه عن أصله، فكان من شأن ذلك أن أرادوا العودة إلى الأصل لمشاهدة الحق بقلوبهم.
فعن التجلى الأعظم في صفات الحق ظهر المظهر الأعظم في صفات ذات الخلق، ومن هذا المظهر تكمن معرفة جماله وجلاله.
والحال هذه إن حب المعرفة ـ هنا ـ مرهون بالمستوى الخصوصي، وهو ما استلخصة ابن عربي في نوعين من الحب. الأول: إلهي أزلي، والثاني: إنساني في توحده بالذات الإلهية، وأن المبدأ الذي يحكم النوع الاول: هو ” الجمال الاقدس ” في صفته الجوهرية، النابع من ( صفة الجمال الإلهي الذي أشرق على الكائنات في حالة ثبوتها الأزلي، فأخرجها من بطونها إلى ظهورها الوجودي، وبذلك جاء وجودها مظهرا للجمال الإلهي الأزلي، وسبب ذلك الظهور حب الله القديم في أن يعرف، وكان تجليه في العالم لأجل هذه الغاية، وأما الحب الإلهي ـ يقول ابن عربي ـ فمن اسمه الجميل، والنور، فيتقدم النور إلى أعيان الممكنات، فينفَر عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكانها فيحدث لها بصرا … فيتجلى لتلك العين الإسم الجميل فتتعشق به، فيصير عين ذلك الممكن مظهورا له[36] .
جـ ـــ الكمال كنه الكائن / كمال الكمال
مر بنا أن الجمال عند المتصوفة ليس هو الحقيقة المتحققة في الوجود بما هو غاية، بقدر ما هو واسطة لظهور الوجود بين ذات الحق وفعل الوجود الذي يعكس صورة التمام / الكمال، وبيان ذلك أن نور الحق يكون قد خرج في جميع كمالاته الى الوجود منبسطا على كل ماهو موجود، وهو مع كونه مقدسا عن كل موجود فإن وجوده هو حقيقة الوجود، وأن جميع صفاته الكمالية هي عبر ذاته. ومن هنا يرى ابن سبعين أن الكمال بالأصالة وهو الكل بالمطابقة، وهو عين الكمال وغاية الجلال بالتضمن، على عكس ما يراه في حق كمال الإنسان الذي هو النقص بالأصالة والجزء بالمطابقة، وفي ذلك تأكيد من ابن سبعين على الوحدة المطلقة في الكمال الماهوي (الماهية ) أي كمال الحق في مطابقته ـ أيضا ـ للوجود كله مما يؤدي إلى أن يكون من حيث المعنى عين الكمال وسر الجمال وغاية الجلال[37] .
كما اعتبر الملاصدرا[38] الشيرازي أن وجوده تعالى كله الوجود لكونه صرف حقيقة الوجود، وجودا لجميع الموجودات ” لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ” فلا يخرج من كنه ذاته شيئ من الأشياء لأنه تمام كل شئ ومبدؤه وغايته، وإنما يتعدد ويتكاثر وينفصل لأجل نقصاناتها وإمكانـاتهـا
وقصوراتها عند درجة التمام والكمال، فهو الأصل والحقيقة في الوجودية، وماسواه شؤونه وحيثياته. وهو الذات، وماعداه أسماؤه وتجلياته. وهو النور، وماعداه ظلاله ولمعانه. وهو الحق،وماخلا وجهه الكريم باطـل ” كل شيئ هالك إلا وجهه”. القصص88، “ماخلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ” الحِجر85.
ومن هنا يكون الحق قد أضهر فيه جميع كمالاته، ولعل خير من يمثل صورة الكمال ـ هذه ـ هو الإنسان ” لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ” التين4، الذي هو مرآة الحق من باب التجلي بالمثال لتصبح العلاقة قائمة في إثبات مراتب الحق في صورة العالم، وبيان أعيان صفات الخلق التي تعكس صفات الحق، غير أن كمالاته لاترقى إلى الحدوث والقدم، ومرد ذلك كله هو انعكاس فعل التجلى ضمن علاقة المرآة العاكسة، إلا أن فضاء المرآة ـ هذا ـ ليس فضاء بسيطا يمكن اختزاله إلى مباشرته، وإنما هو خيال مكثف يفرض على العارف الذي يريد كشف أسراره،أن يحول المعرفة إلى رؤيا،وأن يحول فضاء العالم من امتداد الاشياء إلى فضاء للحلم[39]
إن الحضور الجمالي، هنا،لايعني فعل الانعكاس الحرفي، بقدر مايعني الرؤية الكشفية، وليس ذلك بمقدور كل إنسان بحسب رأي ابن عربي، إلا من حقق تمكنه، لكونه يكاشف معاني صفات الحق الجمالية ” حيث خلق الله الإنسان مختصرا شريفا فيه معاني العالم الكبير، وجعله نسخة جامعة لما في العالم الكبير، ولما في الحضرة الإلهية من الأسماء،[40] من منظور أن كمال الصورة الإنسانية هنا هو جوهري فيها، مشتملة على جميع الصفات الكمالية لكون الحق تجلى بعبده في صفتي ” الحي القيوم ” كما ورد فـي ذكره جل شأنه لانه يكون بذلك قد دل على ” وجوب الوجود وجوب الايجاد. ” ومن هنا تكون كمالات الوجود بالخلق نسبة إلى الكمالات بالحق، وحينئذ يكاشف العالم الصغيرمعاني صفات الحق الجمالية. ومن هنا ـ أيضا ـ تكون كمالات العالم الصغير التي هي جزء من كمالات العالم الكبير أتم مرآة تعكس صورة كمالات الصفات الالهية.
ولعل الكمال، هنا، كما يصفة الأميرعبد القادرالجزائري، أحد المتصوفة المتأخرين، لايعني المطابقة بين وجود الحق ووجود الخلق،على الرغم من أن الانسان له من حيثية وجوده الأولية والأخرية، تماما كما أن له الظهور والبطون، وهو وإن كانت له هذه الصفات إلا أنها لاتطلق عليه إلا بالنسبة والإضافة ليظهر الفارق بين الحق والخلق، ومن ثمة تقع المماثلة والمفارقة في آن واحد بين الوجود الإلهي والوجود الحق، ومع ذلك فإن هذه المماثلة والمفارقة تظل خصيصة للإنسان بالذات أزلا وأبدا ولا تكون كذلك للعالم بكل مظاهره، لأن العالم رغم أنه مخلوق أيضا على الصورة بوصفه تجليا للصفات الإلهية إلا أن الصورة في الآخرين دون كمالها في الأول … وعلة الآمر أن الكمال الذي تحقق في العالم من جهة الصفات والأسماء، وإن كان هو عين الكمال في الإنسان،إلا أن هذا الكمال كله هو عين الكمال الذي للذات الالهية من حيث إن لها كمالين أولهما هو كمال الذاتي الوجوبي، وهذا لادخل فيه للعالم ولا للإنسان، وثانيها الكمال الصفائي الأسمائي، وهو الذي يكون للعالم والإنسان، لكن الكمال الأسمائي وإن توقف ظهوره لا وجوده بالطبع على ظهور العالم بأجناسه والإنسان خاصة إلا أن العالم يظل بكل مافيه يفتقر إلى الله، وبذلك فوجوده هو عين وجود العالم أو عين وجود الإنسان[41].
وكما كان الجمال عند المتصوفة مرتبطا بالمحبة بوصفها طريقا لاتخاذ معنى جديد إلى محبة الله، على اعتبار أن الجمال في الخليقة مظهر من مظاهر الجمال الالهي المطلق في كماله وتمامة، فإذا كانت المحبة كذلك، فإنها أيضا وثيقة الصلة بمستويات الكمال التي تحدد صفات كمال التوحيد عبر إثبات صفاته عن ذات البارى جل اسمه، على اعتبار أن ” الحق هو المطلوب والذي من أجله يسمى الكمال، وبه كان، وله أريد، ومنه صدر، وإليه يعود، وفيه هو لافي غيره، ومنه يطلب بنفسه لا لغيره ولا تغيره ولا من اجل غيره وبه تعلق الجميع[42].
ومن ثمة يكون الكمال هنا في ثباته مع صفات الجمال بمثابة القيمة الجوهرية لمعني كمالات الوجود التي تعكس صفات ذات الحق، ومن هنا أيضا، تكون العلاقة بين صفتي الجمال والكمال هي علاقة انصهار جامعة لكل مظاهر الألوهية، والكونية، والإنسانيه في ارتباط كلي بانعكاس الصفات، وذلك أن الكمال هو سر الجمال، وفي هذا يؤكد أقطاب الفكر[43] أن الكمال هو مظهر الجلال والجمال، أو هو مادتهما، أو إاكسيرهما، أو ماهيتهما، وفي ذلك يقول الفارابي: الجمال واليها، والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده الأفضل، ويحصل له كماله الأخير[44]، و أن العظمة والجلالة والمجد في الشئ إنما يكون بحسب كماله، يقول ابن سينا: لايمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الماهية عقلية محضة، خيرة محضة، عرية عن كل واحد من أنحاء النقص[45]، اذ ” إن لذة كل قوة فحصول كمالها لها، “وأن جمال كل شئ هو أن يكون على ما يجب له [46]، ويقول لسان الدين بن الخطيب ” الكمال مظهر الجمال ومجلى له، وهـو المادة لصورتـه.[47] ويقول السهروردي ” إن جمال كل شئ هـو حصول كمالـه اللائق بـه.[48] وابن قضيب البان يرى أن الروح هو تلطف تولد الجمال والجلال عند امتزاجهما لظهور صورة الكمال[49] . أما أبو حامد الغزالي فيقول: كل شئ فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به، الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو فـي غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر مـا حضر[50] .
لا شك في أن صفات الكمال بمظاهرها الجمالية ينبغي أن تكون شاملة لنعوت ذات الحق، ومعرفة جماله وجلاله، وأن تكون مظهرا من مظاهر حقائق الممكنات على صفاتها لكونها علاقة للجمال والكمال في الظاهر والباطن، وهو ما أشار إليه ابن الدباغ حين تعرضه لمعنى الجمال والكمال، مبرزا صفات الكمال بوصفه سر وجود الجمال بقوله: أما الكمال فمعناه حضور جميع الصفات المحمودة للشئ. وقد قسمه إلى ظاهر وباطن. وعنده أن الكمال الظاهر مظهر للجمال، أو الجمال ذاته، عبر ما تجلى فيه من حقائق صفاته، ومن خلال العلاقة الحميمة التي تربط سلامة الإنسان بأحاسيسه وذوقه الرفيع لما هناك من تأثير الكمال الظاهر على النفس، وهو ما أبرزه ابن الدباغ: ” أما الظاهر فهو اجتماع محاسن صفات الأجسام اللائقة بها وهو يختلف باختلاف الذوات، فكمال كل شئ بحسب مايليق به، فالذي يكمل به شئ غير الذي يكمل به شئ غيره … ولذلك الذي يكمل جنسا من الأجناس غير الذي يكمل الجنس الآخر، حتى أن الذي يكمل عضوا من أعضاء البدن غير الذي يكمل العضو الآخر … فهذا هو الكمال الظاهر، والنفوس تتأثر به لأنه مظهر الجمال المحبوب بالطبع الروحاني والنفساني إذ الإنسان السليم من الآفات يحب الصورة الحسنة الخلق، وينفر من الصورة المشوهة المنكوسة، أو التي فيها نقص أوشين..فالإنسان على هذا يجانس النبات بالنفس النباتية، والحيوان بالنفس الحيوانية،والملائكة بالنفس الإلهية[51] .
ولعل علاقة سلامة الإنسان بالإحساس بالجمال يعد ضربامن الوعي المبكر في التفكير بالجمال عند الفلافسة والمتصوفة المسلمين على اعتبار أن الجمال ليس بالوسائط التي فصل فيها بن الدباغ مثل الأنغام والألحان والأرايح الطبية والأصوات الرخمة، وإنما هو ما ينجلى الجمال فيها وعبرها.
إن دراسة صفات الكمال تفضى بنا إلى ربط العلاقة بينها وبين صفتي الجمال والجلال، لأن مقولة الوجود الأكمل نابعة من مقولة الجوهر الأتم في إرادته الإبداعية، كيف يشاء على الوجه الأتم من كمالات ذاته. ومن هنا كان الكمال لصفات الحق هو الجوهر في إثبات الوجود من حيث هو جوهر الأشياء، وليس هو الأشياء، وهو ما نلمسه في حقيقة وجود الصوفي الذي يستدعي البحث عن الآخر في كشف حقائقه الصفاتية ومالها من التجلي والقدرة الإبداعية، من ذات الحق، وبيان ذلك أن ما تقتضيه الصفات الكمالية ضمن الصورة الانعكاسية التى تدل على ربط الصلة بين ذات الحق في الوجود ” الظاهر ” وذات الخلق بمحاولة انكشاف المحجوب “الباطن ” يكون من شأنه أن الحق أحب الخلق فأخرج كمالاته إلى الفعل، بينما اشتاق الخلق الظاهر في وجوده المتعدد إلى العودة عبر كشف صفات الجمال القدسي “الباطن ” وليس فقط عبر وجود الظاهر في بديع أشكاله وتناسب مرئياته على اعتبار أن ” كل جمال في العالم العلوي والسفـلي ( فمن الحق ) ظهر، وبه وجد، وعنه اشرق على سائر الذوات، وما تفرق في جميع ذوات الوجود، بالإضافة إلى جماله نقص محض، إذ لا يعطي الجمال إلا من هم أجمل منه، بل هو القيوم الذي قام به سائر ذوات الموجودات[52] . لذا أقر المتصوفة الجمال في ذواتهم وما كان منهم إلا أن استدلوا على المحبة الإلهية التي تكسبهم القدرة على كشف جمال الحق عن طريق إدراك الوجود، والترفع عنه إلى النظر في ذات الحق من خلال مقتضى الحال بالنظر المجرد من دعاهم أن يعتبروا كما ورد على لسان أحدهم مثلا:
وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو علي من الشهود
ومالي في الوجود كثير حـظ ولكن وجد موجد ذا الوجود
[1] ينظر أحمد عبد المهيمن: نظرية المعرفة بين ابن رشد و ابن عربي، دار الوفاء 2000ص 116
[2] ينظر المرجع السابق ص 112
1 المرجع السابق ص 114
2 نفسه ص 339
[3] ما نقصده بالحلول، هنا ـ وكما سيرد لاحقا ـ وهو: اتحاد ذات الخلق بذات الحق، اتحاد معنويا لا اتحاد العين بالعين، أو امتزاج الذات والذات.إنه نوع من التشابه والتماثل، أو قل هو التفاني في محبة الفرد للآخر. ينظر د. حسن الفاتح قريب الله: فلسفة وحدة الوجود،الدار المصرية اللبنانية، 1996 ص، 190 ـ 191.
[4] ورد الحديث بصيغ مختلفة ـ ينظر جامع الأحاديث للسيوطي 4 / 711.
[5] محمد غنيمي هلال: الحياة العاطفية بين الغذرية والصوفية، دار نهضة مصر 1976، ص 220.
[6] الفتوحات المكية، دار صادر بيروت، 2 / 111.
[7] محمد غنيمي هلال: مرجع سابق، 222.
[8] وفي ذلك آيات كثيرة من الذكر الحكيم منها قوله عز وجل: قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الـله (آل عمران31) فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ( المائدة 54) يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ( البقرة 165).
[9] الاتحاد عند بعض الصوفية: هو أن تبلغ الاتصال بالله حدا يتلاشى فيه الازدواج بين المحب والمحبوب إذ يصبحان شيئا واحدا في الجوهر والفعل.. وحينما يتحقق الاتحاد تختفي الإشارة إلى كل من (الصوفي والله).
[10] هونري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نصير مروه وحسن قبيسي، منشورات عويدات، 1966، ص 290.
[11] اللمع 463.
[12] ينظر د. تراكي زناد بوشرارة: أمكنة الجسد في الإسلام ترجمة زينة نجار كفروني دار سعاد الصباح 1996 ص 51 وما بعدها.
[13] كشف المحجوب 554 عن: منصف عبد الحق: الكتابة والتجربة الصوفية 370.
[14] نفسه، 554.
[15] هو أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي (ت 536 هـ) صاحب كتاب: محاسن المجالس. ويروي أن ابن عربي قد اعتمد عليه في تأصيله ” وحدة الوجود “.
[16] تذكرة الأولياء 1/ 160 عن، سالم جميش: في التصوف بين التجربة وإنتاج الجمال، مجلة الوحدة، ع 24 / 1986، ص 152.
[17] ينظر، نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه، ترجمة أبو العلا عفيفي / القاهرة 1969، ط 93ـ 94.
[18] المرجع السابق، ص 92.
[19] ديوان شمس تبريز 342 عن: في التصوف الإسلامي وتاريخه 93.
[20] الفتوحات المكية 2/326.
[21] في التصوف الإسلامي وتاريخه ( مرجع سابق ) ص 87.
[22] الفتوحات المكية 2/ 326.
[23] المواقف ج 3، موقف 338 ص 49 ـ 50 وانظر أيضا: د. أحمد محمد الجزار: الله والإنسان عند الأمير عبد القادر الجزائري، مكتبة الأسرار ـ القاهرة 1994، ص 84.
[24] ينظر. عبد اللطيف محرز: الإنسان في ظل القرآن، اتحاد الكتاب العرب دمشق، 1996 ص 249ـ 252.
[25] ينظر. د. محمد عنيمي هلال: الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية، ص 195
[26] كتاب التجليات. ضمن رسائل حيدر اباد، دار احياء التراث العربي، ص 42
[27] ينظر، الكتابة والتجربة الصوفية ( مرجع سابق ) 513
[28] الفتوحات المكية 4 / 269
[29] فصوص الحكم: فص حكمة إلهية في كلمة آدمية. عن النزعات المادية 2 / 276
[30] ينظر. النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية، 279.
[31] التأويل الصوفي يلغي العمل بالإسناد الشائع في التفاسير السنية، ويحل محله ما اسماه بالتخريج، وهو عبارة عن تولد إسقاطي لمقولات، وسط فناء صاف من الأقوال المتوارثة فضاء حيث يتم كل تحديد مفهومي انطلاقا من المحدودية الجذرية للإنسان وحولها. ينظر، سالم حميش في التصوف بين التجربة وانتاج الجمال، مجلة الوحدة ع 24 / 1986 ص 146.
[32] سالم حميش: في التصوف بين التجربة وانتاج الجمال، مجلة الوحدة 146.
[33] محمد غنيمي هلال: الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية 187
[34] لقد اعتمد المتصوفة هذا الحديث وبنوا علية أصولهم إلا أن كثيرا من الفقهاء والمفسرين يشكّون في هذا الحديث، ومنهم ابن تيمية بقوله: ليس هذا الحديث من كلام النبي، ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. بينما يعتبره البعض الآخر صحيحا، وأن معناه مستفاد من قوله تعالى: ” وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ” أي ليعرفوني، كما فسره ابن عباس. ينظر، محمد غنيمي هلال: الحياة العاطفية بين العذية والصوفية. ص 187.
[35] ينظر، منصف عبد الحق: الكتابة والتجربة الصوفية 403 وانظر ايضا الفتوحات المكية 2 / 222 – 223.
[36] الفتوحات المكية 2 / 112
[37] ينظر، رسائل ابن سبعين، تحقيق: عبدالرحمن بدوي 144. عن مفهوم الكمال في الفكر العربي الاسلامي: سعد الدين كليب، مجلة المعرفة السورية.ع. 371/ 1994 ص،15 16.
[38] صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي (الشهير بصدر المتأهلين الملا صدرا): أسرار الآيات. تقديم وتصحيح محمد خواوجي. دار الصفوة، بيروت، ص 37.
[39] منصف عبد الحق: الكتابة والتجربة الصوفية، ص 292
[40] ينظر: ابن عربي: التميزات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية (ضمن كتاب إنشاء الدوائر) ص 108. عن، مفهوم الكمال في الفكر العربي الاسلامي ( مرجع سابق ). ص 25
[41] ينظر: المواقف الامير عبدالقادر الجزائري 3 / 143. وانظر ايضا: الله والانسان عند الامير عبدالقادر الجزائري (لأحمد محمد الجزار، مكتبة الاسرار مصر 1994 ص 67 – 68.
[42] ابن سبعين: بدّ العارف، تحقيق جورج كتورة، دار الاندلس،،1978 ص 353.
[43] لقد استعنا في ذلك بما أورده سعد الدين كليب من نصوص في دراسته القيمة:” مفهوم الكمال في الفكر العربي الاسلامي”. كما تبينه النصوص اللاحقة المستمدة من،ص 10 – 11. ( مرجع سابق )
[44] ينظر: أهل المدينه الفاضلة، مطبعة التقدم، القاهر 1970، ص 20.
[45] المبدأ والمعاد، باهتمام عبدالله الحوراني، طهران، 1984، ص 17 – 18.
[46] ابن سينا: النجاة، ص 245.
[47] روضة التعريف بالحب الشريف ( تح ) عبدالقادر عطا. دار الفكر العربي، ص 287 .
[48] اللمحات ( تح ) أمين معلوف، دار النهار، 1969، ص 131.
[49] المواقف الإلهية. في كتاب الانسان الكامل في الاسلام ( تح ) عبد الرحمن بدوي، الكويت 1976، ص 208
[50] إحياء علوم الدين، دار المعرفة، 4 / 299
[51] محمد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، المعروف، (بابن الدباغ): مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب. تحقيق ربيتر دار، صادر، 39-40.
[52] ابن الدباغ: مشارق انوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب ص 56
 ilmolmabdaa علم المبدأ
ilmolmabdaa علم المبدأ